|
"الإخوان
المسلمون".. ما بعد مشهور
ضياء
رشوان **
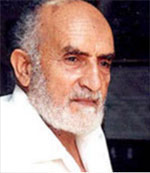 |
|
مصطفى
مشهور
|
لم
يكد يمر عام على أحداث 11 سبتمبر في
الولايات المتحدة الأمريكية التي
أصابت الإخوان المسلمين في مصر مثل
غيرهم من مختلف الحركات الإسلامية في
العالم بعديد من الآثار السلبية.. حتى
أصيبت الجماعة -المحظورة رسمياً في
مصر منذ نحو خمسين عامًا- بضربة أخرى،
مثّلها رحيل مرشدها العام الخامس
مصطفى مشهور (1921-2002) في ظل ظروف دقيقة
داخل الجماعة وأخرى أحاطت بها على
المستويين المحلي والدولي.
فأما
عن آثار أحداث سبتمبر؛ فبالرغم من أن
الحرب الواسعة التي تقودها الولايات
المتحدة الأمريكية منذ أحداث سبتمبر
ضد الغالبية الساحقة من الحركات
الإسلامية في العالم تحت مسمى "القضاء
على الإرهاب" لم تلحق بالإخوان
إصابات مباشرة أو كبيرة؛ فقد تأثرت
الحركة الإسلامية السياسية الأقدم في
العالم كثيراً بتلك الحرب غير
المسبوقة في التاريخ. فعلى الصعيد
العالمي كان لمناخ التضييق العام ذي
الوجوه الأمنية والسياسية
والإعلامية المتعددة على كافة
الحركات والأنشطة الإسلامية.. تأثيره
السلبي على مختلف فروع الإخوان
المسلمين في معظم دول العالم التي
جنحت إلى الكمون التنظيمي، وتقلصت
نشاطاتها العامة.
كما
أنه على نفس الصعيد العالمي طالت
الإجراءات الأمنية الأمريكية
الغربية بعضًا من هياكل الجماعة
وقياداتها بتهمة "دعم الأنشطة
الإرهابية"، كما حدث في تجميد
أموال بنك التقوى الوثيق الصلة
بالجماعة. وفي نفس سياق ما بعد سبتمبر
لا يمكن تجاهل تزايد الحملات الأمنية
والإعلامية على بعض فروع الجماعة في
عدد من البلدان، بغض النظر عن وضعها
القانوني فيها، مثلما حدث في الأردن
التي تتمتع فيها الجماعة بالشرعية
القانونية أو في مصر التي لا يزال
الحظر القانوني على وجودها قائمًا.
في
ظل ذلك المناخ أتى غياب المرشد العام
للجماعة لكي يخرج إلى الأضواء حقيقة
ما يمر به الإخوان في مصر من تطورات
وتفاعلات داخلية عميقة. والحديث عن
طبيعة تلك التطورات والتفاعلات
الداخلية يجب أن يضع في اعتباره
نقطتين رئيسيتين: الأولى: هي أننا
بصدد جماعة سياسية اجتماعية ذات
برنامج إسلامي عام، لا تختلف في
طبيعتها أو تكوينها العام عن غيرها من
الجماعات المماثلة من اليمين أو
اليسار أو الوسط سوى في مضمون
برنامجها. وبالتالي فمن الطبيعي أن
تتعرض -كغيرها من تلك الجماعات
المماثلة- لعديد من التطورات
والتفاعلات الداخلية التي قد تصل
أحيانًا إلى درجة الخلافات متعددة
المستويات والمظاهر.
من
ناحية ثانية فمن الضروري عند تحليل
تلك التطورات والتفاعلات بداخل
الإخوان المسلمين الانتباه إلى مدى
تأثير السياقات المحيطة بها عليها،
سواء كانت محلية مصرية أو إقليمية أو
عالمية، على ألا يقتصر النظر إلى تلك
السياقات في حالتها الراهنة الثابتة..
بل يمتد إلى تطورها عبر المراحل
التاريخية السابقة، والتي أفضت في
النهاية إلى صورتها الحالية.
بين
"الشرعية التاريخية" و"الشرعية
الواقعية"
ضمن
النقطتين المنهجيتين السابقتين يبدو
الوضع الداخلي للإخوان المسلمين في
مصر اليوم كحصيلة منطقية للتطور
التاريخي الذي عرفته الجماعة خلال
الأعوام الثلاثين الماضية بعد إفراج
الرئيس السادات عن قياداتها وأعضائها
من السجون، والسماح لهم بالتحرك
بصورة شبه علنية كجماعة منظمة. فتلك
الأعوام الثلاثون من تاريخ الحركة
يمكن تسميتها "مرحلة التأسيس
الثاني" لها، بعد التأسيس الأول
على يد الأستاذ حسن البنا عام 1928. وقد
تم هذا "التأسيس الثاني" للجماعة
بفضل مجهودات قيادات مرحلة تأسيسها
الأولى، الذين خرج معظمهم حينئذ من
السجون، والذين عاد بعضهم من المنافي
الاختيارية الخليجية، بالإضافة إلى
مجهودات عديد من الدعاة والقيادات
الإسلامية المستقلة عن الجماعة،
والذين انتشرت تسجيلات خطبهم
وكتاباتهم بصورة واسعة بين طلاب
الجامعات المصرية، الذين مثلوا
الشريحة الرئيسية التي توجهت إليها
مجهودات كل هؤلاء.
أسفرت
تلك المجهودات المتكاملة، وفي ظل
مناخ إسلامي عام تبنته وأشاعته
الدولة الساداتية في سنواتها الأولى
عن جذب أعداد ضخمة من هؤلاء الطلاب -وبخاصة
في جامعات القاهرة والوجه البحري
والإسكندرية- إلى صفوف الجماعة التي
بدت لمعظمهم الكيانَ الوحيد القادر
على تلبية معظم حاجاتهم: الحاجات
الدينية والثقافية بما قدمته لهم من
إطار إسلامي، وهوية واضحة طال بحثهم
عنها في تلك الفترة المتخمة
بالاضطراب والفوضى والحاجات
الاجتماعية بما وفرته من خدمات
تعليمية وطلابية وأطر مناسبة للتفاعل
بين أبناء تلك الشريحة العمرية،
والحاجات السياسية بما أتاحته من
نشاطات جامعية نوعية ضمن مؤسسات
التمثيل الطلابي، وأخرى أوسع تتقاطع
مع هموم المجتمع العامة.
وقد
زاد بريق الجماعة لتلك الشريحة
الأنشط دائماً في التاريخ السياسي
المصري المعاصر والأكثر احتجاجاً،
بعدما بدأت في الصدام مع الدولة بعد
قيام الرئيس السادات بزيارته
المفاجئة للقدس في نوفمبر 1977؛ مما
أتاح لها مزيداً من الانتشار بين
صفوفها وجذب مزيد من أبنائها إليها.
السبعينيات..
التأسيس الثاني
وقد
كانت فترة النصف الثاني من
السبعينيات هي بداية "مرحلة
التأسيس الثاني" للجماعة؛ لأنها
أتاحت لها جذب هذه الأعداد الوفيرة من
تلك الشريحة الاجتماعية الأكثر
نشاطاً؛ لكي تجدد بهم صفوفها بعد أن
تجمدت تقريباً -بسبب ظروف الصدام
الواسع مع النظام الناصري- عند نفس
الجيل الذي ساهم في تأسيسها الأول،
والذي تراوحت أعمار من ينتمون إليه
حينذاك بين الخمسين والستين.
كما
كان الانضمام الواسع لأبناء تلك
الشريحة إلى الجماعة بمثابة "التأسيس
الثاني" والإنقاذ الحقيقي لها من
التراجع أمام صعود الجماعات
الإسلامية الأخرى ذات الطابع الديني
الجهادي المائل إلى العنف، والتي
نجحت -بسبب طابعها المتشدد- في جذب
قطاعات واسعة من نفس الشريحة، بخاصة
في جامعات جنوب مصر.
ولا
شك أن دخول الجماعة إلى الصدام مع
الرئيس السادات بعد زيارته للقدس،
وعقده معاهدة السلام مع الدولة
العبرية، ثم استقباله شاه إيران بعد
قيام الثورة الإسلامية هناك عام 1979،
وهو ما تصاعد بفعل ضغوط الوافدين
الجدد على صفوفها من طلاب الجامعات..
قد ساهم بدوره في إضفاء طابع احتجاجي
عليها، ساعد هؤلاء على جذب أعداد أكبر
من زملائهم إليها، وسحبهم بعيداً عن
الجماعات الإسلامية الجهادية الأخرى
التي كانت تعيب على الجماعة
اعتدالها، ووسطية أطروحاتها،
وتجنبها الصدام مع الدولة.
وباغتيال
الرئيس السادات في أكتوبر 1981 وبدء
تفكك حالة التوتر والتصعيد التي خيمت
على مصر خلال أعوام حكمه الأربعة
الأخيرة، راح أبناء ذلك الجيل الجديد
الذين ضمتهم الجماعة إليها أثناءها
ينشطون في إعادة تأسيس الجماعة
وبنائها، بعد أن تخرجوا في الجامعات،
وصاروا أبناء مهن ذات وزن في المجتمع.
وخلال السنوات التالية التي تقارب
العشرين استطاع هذا الجيل أن يحقق
للجماعة على المستوى السياسي
والنقابي في مصر ما لم يتحقق لها من
قبل طيلة تاريخها السابق.. فقد اكتسحت
الجماعة ممثلة بهؤلاء انتخابات معظم
النقابات المهنية المصرية ونوادي
هيئات التدريس بمختلف الجامعات،
فضلاً عن اتحاداتها الطلابية. كذلك
فقد استطاعت الجماعة -رغم الحظر
القانوني المستمر عليها- أن تدخل
أعضاء منها إلى مجلس الشعب، معظمهم من
أبناء ذلك الجيل في 3 انتخابات (أعوام
1984 و1987 و2000)، محققة في الأخيرتين
منهما الموقع الثاني من حيث العدد بعد
الحزب الوطني الحاكم.
ونجح
أبناء الجيل الثاني أيضاً في بناء
كثير من جسور الحوار والتنسيق بين
الجماعة ومعظم قوى المعارضة السياسية
في البلاد من اليسار واليمين عبر
أقرانهم فيها، بعد أن كانت قد تقطعت
بين أبناء الجيل الأكبر في الجماعة
ونظرائهم في تلك القوى خلال "مرحلة
التأسيس الأولى". وقبل كل ذلك فقد
نجح أبناء الجيل الثاني الذين تتراوح
أعمارهم اليوم بين الخامسة والأربعين
والخامسة والخمسين في أن يضموا جيلاً
ثالثاً للجماعة يصغرهم ما بين عشرين
وخمسة وعشرين عاماً من خلال نشاطاتهم
النقابية والسياسية والإعلامية
والطلابية، وبخاصة بعد أن زاد بريق
الجماعة الإسلامي المعتدل في ظل
تراجع وزن وجاذبية جماعات العنف
الإسلامي المتشددة بدءاً من النصف
الثاني للتسعينيات.
التناقض
الجيلي
خلال
ذلك الصعود المتتابع لدور وأهمية
الجيل الثاني في "التأسيس الثاني"
للجماعة واستمرارها.. راحت تتشكل له
تدريجيًّا بداخل صفوفها وبين القوى
الأخرى خارجها شرعية يمكن تسميتها
"الشرعية الواقعية"، في الوقت
الذي ظلت فيه قيادة الجماعة -ممثلة في
مرشدها العام، ومكتب الإرشاد، ومجلس
الشورى- خاضعة لأغلبية واضحة من أبناء
الجيل الأول بما له من "شرعية
تاريخية" استمدها من دوره خلال
مرحلة "التأسيس الأول" لها
وبداية المرحلة الثانية.
وعلى
الرغم من أن الجيل الأول قد أفسح بعض
المجالات والمواقع للجيل الثاني في
بعض الهياكل القيادية للجماعة بدءاً
من منتصف التسعينيات؛ فقد ظلت نسبته
فيها أقل بكثير من دوره ونسبته
الحقيقية في مختلف مستويات وصفوف
الجماعة، وظلت قضية المواءمة بين "الشرعية
التاريخية" و"الشرعية الواقعية"
هي الأكثر إلحاحاً بداخلها برغم
النفي العلني لمعظم الأطراف لحقيقة
وجودها. ولم يكن ذلك التناقض بين
شرعيتي الجيلين غريبًا عن السياق
السياسي المصري الأوسع من الجماعة؛
حيث بدا متكرراً بصور مختلفة المضمون
بداخل كل القوى السياسية المصرية
التي هيمن عليها جميعاً جيل "الشرعية
التاريخية" الأول، وبدت الجماعة
بذلك جزءًا أصيلاً من الحياة
السياسية المصرية، على الرغم من
تفوقها الظاهر على نظرائها في معسكر
المعارضة، سواء من حيث طريقة الأداء
أو حجم الإنجاز.
إلا
أن الفارق الأكثر وضوحاً بين التناقض
الجيلي بداخل الجماعة وأمثاله في
الجماعات السياسية الأخرى هو عدم
ارتباطه بتناقض في الرؤى السياسية
والاجتماعية؛ أي بين الرؤية "الجذرية"
للجيل الأصغر مقابل الرؤية "المحافظة"
للجيل الأكبر؛ فالحقيقة أن هاتين
الرؤيتين توجدان على حد سواء بين
أبناء كل من الجيلين على اختلافهما من
حيث التكوين والخبرة والطبيعة، وهو
الاختلاف الأكثر أهمية وتأثيراً في
حالة الإخوان المسلمين؛ فعلى الرغم
من اشتراك الجيلين في انتمائهما إلى
الشرائح الوسطى من الطبقة الوسطى
الحضرية والريفية المصرية.. فهما
يختلفان إلى حد بعيد في الخبرة
والعلاقة مع الدولة والقوى السياسية
الأخرى. فالجيل الأول نشأ في مرحلة ما
قبل الثورة وسط اختلافات ومصادمات
الجماعة مع مختلف القوى الوطنية
المصرية، بالرغم من اتفاق المقاصد
على استقلال البلاد من الاحتلال
البريطاني، وتذبذب مواقفها من النظام
الملكي بين تأييد ظاهري وعداء صريح.
ولم يكد معظم أبناء ذلك الجيل يخطون
نحو الثلاثينيات من أعمارهم حتى كانت
الجماعة تخوض أولى مصادماتها الدموية
مع الدولة، والتي فقدت فيها مؤسسها
ومرشدها الأول الأستاذ حسن البنا عام
1949. وما هي إلا أعوام أربعة أخرى حتى
دخل أبناء نفس الجيل صدامهم الأوسع من
نظام يوليو الثوري الجديد، والذي كلف
معظمهم نحو 20 عاماً من السجن أو النفي
الاختياري والإجباري أو الاستبعاد من
الحياة العامة.
ولم
يكن لتلك الخبرة المبكرة والطويلة
سوى أن تطبع ذلك الجيل بخصائص واضحة
في علاقته المضطربة بالقوى السياسة
المعارضة الأخرى، وشكوكه في إخلاصها
لتعاقداتها وتحالفاتها، فضلاً عن
عدائه الشديد لبعضها، وتخوفاته وحذره
المستمرين من الدولة التي زادت
مواقفها تجاه الجماعة خلال السنوات
العشر الأخيرة من عمقها واتساعها.
أما
الجيل الثاني فقد بدأ خبرته مع
الجماعة في النصف الثاني من
السبعينيات بالجامعات المصرية؛ حيث
تشارك أبناؤه مع عديد من نظرائهم في
القوى السياسية الأخرى حركة سياسة
طلابية واسعة معارضة لسياسات الرئيس
السادات وبخاصة الخارجية منها،
بالرغم من نشوب خلافات عديدة بينهم
وصلت أحياناً إلى حد التصادم. وبالرغم
من نشاط هذا الجيل الثاني المعارض
للدولة فقد ظل بعيداً عن سجونها
وقبضتها الثقيلة التي أصابت الجيل
الأول من قبل؛ حيث لم يدخلها ويشعر
بوطأتها سوى مع النصف الثاني
للتسعينيات، ولفترة قصيرة قبل ذلك
سبقت وتلت اغتيال الرئيس السادات في
أكتوبر 1981. وبتلك البدايات والخبرة
المختلفة تحرر الجيل الثاني أكثر من
سابقه من اضطراب علاقاته وشكوكه في
القوى المعارضة الأخرى، وبخاصة مع
نظرائه فيها زملاء الحركة السياسية
الجامعية في السبعينيات، وكذلك من
تخوفاته وحذره من الدولة بالرغم من
احتفاظه برؤيته النقدية لتكوينها
ولمختلف سياساتها الداخلية
والخارجية. وفي ظل تلك الخبرة
المختلفة راح التطلع نحو حصول
الجماعة على موقع شرعي في الساحة
السياسية المصرية أسوة بالقوى الأخرى
يجتاح ذلك الجيل الذي واصل نشر تطلعه
في صفوف الجماعة ومستوياتها، بالرغم
من حذر الجيل الأول من الفكرة
وتخوفاته "الأمنية" تجاهها.
أسباب
اختلاف الجيل الثاني
وقد
زاد اختلاف الجيل الثاني عن سابقه
بفعل عوامل ثلاثة مهمة: الأول هو خبرة
الاحتكاك بالعالم الخارجي، وما يضمه
من قوى إسلامية وغير إسلامية، وهو ما
لم يتوفر للجيل الأول بحكم ظروفه
الخاصة والسياق التاريخي الذي نشأ
فيه، وبخاصة التعرف على كل من التجارب
الإسلامية في إيران وتركيا والجزائر
والسعي للاستفادة مصريًّا من
نجاحاتها وعثراتها.
وتمثل
العامل الثاني المهم في تعرض الجيل
الثاني لمؤثرات فكرية جديدة أتته من
مصادر ثلاثة رئيسية، وجدت طريقها
إليه بعد رحيل الغالبية الساحقة من
مفكري الجيل الأول التقليديين من
الإخوان. وقد تمثل المصدر الأول في
الكُتّاب والمفكرين المستقلين الذين
تحولوا إلى الأفكار الإسلامية بعد
سنوات طويلة قضوها في تيارات فكرية
وسياسية أخرى، والذين زاد ارتباط
الجيل الثاني بما يطرحونه من رؤى أكثر
عصرية للبرنامج الإسلامي، مثل
المستشار طارق البشري، والأستاذ فهمي
هويدي، والمرحوم عادل حسين،
والدكتورين: عبد الوهاب المسيري،
ومحمد عمارة، والمرحومين حامد ربيع
وجمال حمدان.
وتمثل
المصدر الثاني للمؤثرات الفكرية
الجديدة في بعض المفكرين والكتاب من
أصحاب التوجه الإسلامي الأصيل غير
المرتبطين تنظيمياً بالجماعة وذوي
الخبرة الواسعة دولياً أو في علاقتهم
بالدولة مثل الدكتورين كمال أبو
المجد ومحمد سليم العوا.
وتمثل
المصدر الثالث لتلك المؤثرات الجديدة
في بعض مفكري الإخوان التقليديين
الذين سارعوا بالارتباط بالعصر
وقضاياه، وأخضعوا رؤاهم لتغيراته،
ويعد أبرزهم الشيخ يوسف القرضاوي
صاحب التأثير الطاغي على ذلك الجيل
الثاني.
أما
العامل الثالث المهم في تكوين الجيل
الثاني، واختلافه عن سابقه؛ فقد تمثل
في اتساع دائرة النشاط الإعلامي
لأبنائه وقياداته، واضطرارهم
للتعامل شبه المنتظم مع وسائل
الإعلام العامة والموجهة لقطاعات
واسعة من الجماهير العربية
والإسلامية؛ الأمر الذي أثر كثيراً
في شكل ومضمون خطابهم، وبالتالي
أفكارهم، وهو ما لم يعرفه الجيل الأول
الذي اعتاد على التوجه من خلال وسائله
الإعلامية الخاصة ذات الطبيعة
الإسلامية وليس الوسائل العامة.
السياق
الخارجي: العلاقة مع الدولة
أحاطت
بالتطورات الداخلية السابقة في
الإخوان المسلمين ومرحلة "التأسيس
الثاني" علاقة مضطربة مع الدولة
المصرية، بدت آخر مراحلها تلك
التالية لأحداث سبتمبر، والتي شهد كل
شهرين منها تقريباً إلقاء القبض على
أعداد كبيرة من أعضاء الجماعة،
وإحالة معظمهم إلى محاكم عسكرية،
تصدر أحكاماً على غالبيتهم تصل إلى
السجن خمس سنوات. وفي كل تلك المرات
وُجهت إلى أعضاء وقياديي الجماعة
المحظورة قانونًا نفس الاتهامات
تقريباً (أي تشكيل تنظيم سري مناهض
لنظام الحكم، وحيازة وإحراز منشورات
تحض على قلب هذا النظام، والإعداد
لمظاهرات من شأنها تكدير السلم العام).
وإذا كانت معدلات حملات القبض على
الإخوان المسلمين قد زادت بصورة
واضحة خلال العام الذي تلا أحداث
سبتمبر؛ فهي ليست حدثًا جديدًا.. بل هي
تعبر عن إستراتيجية ثابتة للحكومة
المصرية تجاه الجماعة منذ نهاية عام
1994. وقد سبق للحكومة قبل تبنيها تلك
الإستراتيجية التي يمكن تسميتها "إستراتيجية
الإجهاض المبكر" أن تبنت
إستراتيجيات أخرى مختلفة تجاه
الإخوان منذ عام 1981، وهو ما يبدو
بحاجة إلى مزيد من التحليل لمعرفة
ملامحه ودوافعه.
الدولة
والإخوان.. من التسامح إلى الإجهاض
فقد
مرت علاقة الجماعة بالدولة المصرية
في عهد الرئيس مبارك منذ عام 1981 بثلاث
مراحل: امتدت المرحلة الأولى -التي
يمكن وصفها بمرحلة "التجاهل
والتسامح"- منذ اغتيال الرئيس
السادات وحتى عام 1988 تقريباً، وكان
الهدف الرئيسي فيها للدولة هو تفكيك
حالة التوتر التي واكبت وأعقبت
الاغتيال، على أن يتضمن ذلك خلق شرعية
جديدة للحكم تقوم في جوهرها على فكرة
المصالحة الوطنية، والتفاعل مع القوى
السياسية المصرية الرئيسية. وقد أدى
ذلك إلى تمتع الإخوان المسلمين بقدر
واسع من حرية الحركة والتعبير دون أن
يصل ذلك إلى الاعتراف الرسمي بشرعية
وجودهم. وتلك المرحلة هي التي أتاحت
للإخوان دعم وجودهم السياسي والشعبي
في مصر ومد نفوذهم إلى مؤسسات وقطاعات
سياسية ومهنية لم يصلوا إليها من قبل؛
مثل مجلس الشعب، والنقابات المهنية،
واتحادات الطلاب بالجامعات، ونوادي
هيئات التدريس بها.
وبانتهاء
انتخابات مجلس الشعب لعام 1987 التي
وضحت للدولة فيها القوة الكبيرة
الكامنة للإخوان في ظل تحالفهم مع
حزبي "العمل" و"الأحرار"
تحت شعار "الإسلام هو الحل"،
بدأت المرحلة الثانية في علاقتهم مع
الدولة، والتي يمكن تسميتها مرحلة
"التخوف والاحتكاك"، وهي التي
بدأت فيها الدولة محاولة إيقاف زحف
الإخوان بداخل النقابات المهنية عن
طرق تجميد بعضها، وإثارة المشكلات
بداخل بعضها الآخر، والتي بدأ
الإخوان يتصرفون خلالها باعتبارهم
قوة سياسية شبه شرعية في البلاد.
وفي
عام 1992 استطاع الإخوان السيطرة على
مجلس نقابة المحامين الذي ظل حكراً
طيلة تاريخها تقريباً على التيارين
الليبرالي والحكومي؛ مما زاد من تخوف
الدولة منهم. وفي منتصف نفس العام
اندلعت الموجة الأكثر شراسة للعنف
الإسلامي التي قام بها كل من "الجماعة
الإسلامية" و"جماعة الجهاد"،
والتي أخذت الدولة على الإخوان
أثناءها ما أسمته عدم إدانتهم لها،
والاكتفاء ببيانات عامة فضفاضة.
وهكذا انتقلت علاقة الإخوان بالدولة
منذ بداية عام 1993 وحتى الوقت الحالي
إلى المرحلة الثالثة، وهي مرحلة "التدهور
والصدام". ويمكن إرجاع قرار الدولة
الدخول في مواجهة واسعة مع الجماعة
إلى تزامن انتشارهم في مختلف قطاعات
المجتمع السياسي والنقابي مع موجة
العنف الإسلامي الواسعة الحادة؛
الأمر الذي رأت فيه الدولة وجهين
لظاهرة واحدة هي الصحوة الإسلامية
التي لم ترَ بداخلها فروقاً بين
الإخوان وجماعات العنف الإسلامي.
كذلك فقد رأت الدولة في الجماعة
المحظورة فوق ذلك خطرًا سياسيًّا
زاحفًا يهدد سيطرتها على مقاليد
الحكم في البلاد، وبخاصة بعد
النجاحات التي حققتها في عديد من
الانتخابات العامة والنقابية؛ وهو ما
اعتبرته نواقيس خطر لا بد من الالتفات
إليها والتعامل مع الإخوان على
أساسها؛ باعتبارهم منافسًا سياسيًّا
للدولة يمكنه إذا توافرت الظروف
الملائمة أن يهدد تلك السيطرة.
أهداف
الإجهاض المبكر
من
هنا فإن تلك التخوفات السياسية
والأمنية من الجماعة دفعت الدولة إلى
تبني "إستراتيجية الإجهاض المبكر"
التي سبقت الإشارة إليها في مواجهتها
منذ نهاية عام 1994. وتتضمن تلك
الإستراتيجية توجيه ضربات متتالية
متفرقة للجماعة بإلقاء القبض على
مجموعات منها، وإحالتهم إلى المحاكمة
بحيث تصدر على غالبيتهم أحكام بالسجن
من سنة إلى خمس سنوات. وهذه
الإستراتيجية التي تمت صياغتها قبل
عام من انتخابات مجلس الشعب التي جرت
في نوفمبر 1995 كانت تهدف -ولا تزال- إلى
تحقيق هدفين رئيسيين: الأول هو إنهاك
الجماعة المحظورة بجرها إلى ساحة
القضاء، والحكم على قيادييها
وأعضائها بسنوات سجن متفاوتة المدة،
والاستفادة في ذلك بالوضع القانوني
للجماعة؛ باعتبار أنها لا تملك
تصريحًا قانونيًّا بالتواجد والعمل؛
وهو ما يضع أي نشاط لأعضائها تحت
طائلة القانون.
ويترتب
الهدف الثاني على الأول، وهو حرمان
الجماعة من القدرة على التحرك بكامل
قوتها، خاصة في الحملات السياسية
والانتخابية الرئيسية مثل مجلس الشعب
والنقابات المهنية، والمشاركة في
المناسبات السياسية العامة المصرية
والعربية والإسلامية؛ نظرًا
لانشغالها في الاضطرابات الداخلية
التي تخلفها وراءها حملات القبض
والمحاكمة، وأيضاً لفقدانها عددًا
مهمًّا من قياداتها الرئيسية في تلك
الحملات؛ مما يحرمها من القدرة على
الاستفادة بهم في الحملات الانتخابية
والنشاطات السياسية، سواء كمرشحين أو
كفاعلين قياديين. وقد ركزت الحملات
الحكومية بصفة خاصة على الجيل الثاني
من الإخوان، الذي أنجز لها
انتصاراتها السياسية والانتخابية
سواء في البرلمان أو النقابات
المهنية وصاحب "التأسيس الثاني"
لها، في حين لم تقترب -إلا نادرًا- من
الجيل الأكبر صاحب "التأسيس الأول"
لها الذي تراجعت أهميته في نشاطها
الواقعي لصالح الجيل الثاني .
وبالإضافة
لهذين الهدفين المباشرين لتلك
الإستراتيجية، فهي أيضاً تتضمن هدفًا
آخر أكثر عمومية ومحورية، وهو توجيه
رسالة سياسية واضحة سواء للجماعة أو
للقوى السياسية الأخرى، أو للأطراف
الخارجية المهتمة بأوضاع "الإسلام
السياسي" في مصر؛ مضمونها هو أن
الدولة مصممة على موقفها من عدم
السماح في أي وقت وفي ظل أي ظروف
بإعطاء الجماعة المحظورة وضعًا
قانونيًّا شرعيًّا يمكنها من التفاعل
في الساحة السياسية والاجتماعية
كغيرها من القوى السياسية الشرعية
الأخرى. وقد زاد لجوء الدولة إلى تلك
الإستراتيجية بعد نجاح الإخوان في
الحصول على 17 مقعدًا في انتخابات مجلس
الشعب الأخيرة عام 2000، في الوقت الذي
لم تحصل فيه كل الأحزاب الشرعية إلا
على 16 مقعدًا. ثم أتت بعد كل ذلك أحداث
الحادي عشر من سبتمبر وما بعدها؛ وهو
الأمر الذي قرأت فيه الدولة المصرية
إمكانية تكثيف حملاتها ضد الجماعة في
مصر دون أن تتعرض لضغوط خارجية رسمية
أو من جمعيات حقوقية وقانونية بسبب
تلك الحملات.
وقد
أدى هذان المتغيران إلى زيادة معدلات
تلك الحملات وأعداد المقبوض عليهم،
وكذلك الأحكام الصادرة في حقهم بصورة
أكبر بكثير مما شهدته السنوات
السابقة منذ نهاية عام 1994 الذي بدأت
فيه الحكومة تطبيق "إستراتيجية
الإجهاض المبكر".
اليوم
وغدًا
تقاطعت
التطورات الداخلية في جماعة الإخوان
المسلمين خلال الأعوام الثلاثين
السابقة مع السياق الخارجي المحيط
بها في نفس الفترة؛ لكي ينتهي المشهد
إلى ما هو عليه الآن بعد رحيل المرشد
الخامس الأستاذ مصطفى مشهور. فالضغط
الخارجي المحلي والدولي يتزايد على
الجماعة في نفس الوقت الذي يبدو
الخُلف بين "الشرعية التاريخية"
التي يمثلها الجيل الأول و"الشرعية
الواقعية" التي يمثلها الجيل
الثاني آخذ أيضاً في التزايد. فأصحاب
الشرعية الثانية وأصحاب "التأسيس
الثاني" للجماعة يطمحون إلى إضفاء
شرعية تنظيمية ولائحية على شرعيتهم
الواقعية بالحصول على مزيد من
المواقع الرئيسية في مستويات وهياكل
الجماعة القيادية، بينما يتمسك أصحاب
"التأسيس الأول" بما يرون أن
شرعيتهم التاريخية تعطيه لهم من
سيطرة على تلك المواقع والمستويات
والهياكل. وبينما يخشى الجيل الأول
على الجماعة من قفزات الجيل الثاني
غير المأمونة –حسب رأيه- ويطرح "الاستقرار"
هدفًا رئيسيًّا له في الوقت الحالي
الحرج؛ فإن الجيل الثاني يرى ضرورة
التجديد في فكر الجماعة وحركتها،
والدفع بها نحو الحصول على الشرعية
القانونية التي يرى أنها المخرج
الوحيد لتفاعلها الصحي مع الدولة
والمجتمع في مصر، واستمرارها حية
مؤثرة فيهما.
ولا
شك بذلك أن الحركة الإسلامية
السياسية الكبرى في مصر والعالمين
العربي والإسلامي تمر بمرحلة دقيقة
في تاريخها الطويل الذي يشارف على
ثلاثة أرباع القرن سوف تسفر عن ولادة
جديدة لها. ولا يعني ذلك أن تغيرات
فجائية سوف تشهدها الجماعة خلال
الشهور القادمة؛ حيث من المتوقع أن
تظل القيادة العليا للجماعة في أيدي
الجيل الأول صاحب "الشرعية
التاريخية" مع إفساح مساحات أوسع
تدريجيًّا للجيل الثاني صاحب "الشرعية
الواقعية" لكي يضفي عليها مزيداً
من الشرعية التنظيمية واللائحية. إلا
أن الأكثر توقعًا هو أن تعرف الجماعة
خلال السنوات القليلة القادمة بعضًا
من التوترات الداخلية التي قد تسفر عن
خروج بعض من أبناء الجيل الثاني منها
لصياغة مشروعات إسلامية أصغر بكثير
من الجماعة الأم على غرار مجموعة حزب
الوسط، بينما سيتقدم الباقون منهم
تدريجياً بداخل الجماعة –وهم
الغالبية الكبرى- نحو تحويل شرعيتهم
الواقعية إلى شرعية تنظيمية ولائحية
تكرس مرحلة "التأسيس الثاني"
الذي أقاموه، بل وأيضاً صياغة
شرعيتهم التاريخية الخاصة إذا ما
نجحوا في الحصول على الشرعية
القانونية للجماعة التي لم تتمتع بها
حتى الآن إلا لفترة لا تزيد عن ثلث
عمرها الطويل
|